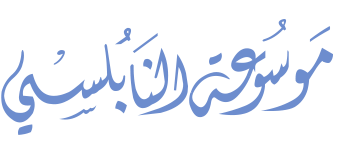- الحديث الشريف / ٠1شرح الحديث الشريف
- /
- ٠4رياض الصالحين
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين, اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم, اللهم علمنا ما ينفعنا, وانفعنا بما علمتنا, وزدنا علماً, وأرنا الحق حقاً, وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلاً, وارزقنا اجتنابه, واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه, وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين .
مقدمة:
أيـها الإخوة المؤمنون؛ ننتقل في هذا الـدرس إلى بابٍ جديد من أبواب رياض الصالحين, للإمام النووي رحمه الله تعالى، والباب عنوانه:
باب القناعة والعفاف, والاقتصاد في المعيشة والإنفاق، وذم السؤال من غير ضرورة، وقبل أن نشرح بعض الأحاديث التي وردت في هذا الباب, لا بد من مقدمة تربط هذه التوجيهات النبوية لأصل العقيدة.
حينما عرض الله سبحانه وتعالى الأمانة على السموات, والأرض, والجبال، وأبين أن يحملنها, وأشفقن منها، وحملها الإنسان, فقال تعالى :
﴿
في هذه الآية: إشارة إلى أن الإنسان قبل حمل الأمانة، وقبل التكليف، وأن هذا الإنسان هو المخلوق الأول، فإذا عرف الإنسان نفسه عرف ربه، دائماً إذا ربطت الفروع بالأصل دائماً تأتي الحركة صحيحة، أما إذا ابتعدت عن الأصل، وبقيت في الفرع، ربما انحرف المسير، وربما ضل الإنسان الطريق، فالإنسان هو الذي قَبِلَ حمل الأمانة.
إذاً:
كأن الإنسان جاء إلى الدنيا ليكون أسعد المخلوقات, حينما يؤدي الأمانة كما أمر الله أن تؤدَّى.
بينما هناك صنفان من المخلوقات: صنف آثر المادة، وصنف آثر الروح.
الملائكة مخلوقاتٌ من نور، عملها الدؤوب: التسبيح والتقديس، وليست مكلَّفةً، وليست مختارةً، وليست مسؤولةً، ولا تحاسب.
والحيوانات من نوع آخر، اختارت الشهوة، وعملها ضمن الاختيار الذي أنيط بها, ليست مسؤولةً، ولا مكلفةً، ولا محاسبة.
لكن هذا المخلوق العجيب: الإنسان الذي جمع الله فيه المادة والروح.
جمع فيه المادة: فله جسد، لهذا الجسد متطلبات، وله نفس، ولهذه النفس متطلبات، تارةً يسمو، فيسبق الملائكة المقربين، وتارة ينحط، فيهوي به انحطاطه إلى أسفل سافلين.
الآن: ما دام الإنسان هو المخلوق الأول الذي قَبِلَ حمل الأمانة، ما الذي يجعله يؤدي هذه المهمة؟ لا شك أنه العمل الصالح، لذلك: إذا عرفت أنك في الدنيا من أجل أن تعمل عملاً صالحاً، والدليل:
﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ
أي أنك جئت إلى دار امتحان، إلى دار ابتلاء، إلى دار تكليف، إلى حياةٍ دُنيا، إلى حياة مؤقتة، إلى وقفة قصيرة، الشيء الذي تفلح به: أن تعمل عملاً صالحاً تلقى الله به، فتسعد به إلى أبد الآبدين.
أن الله سبحانه وتعالى, كان من الممكن, أن يخلق الدنيا بطريقة, حيث لا نعمل.
البيوت جاهزة من دون أن تبني البيوت، الثياب منسوجة ومَخيطة، الطعامُ موجود من دون كسب رزق ولا سعيٍ، كان هذا من الممكن، لأنه كما تعلمون في علم العقيدة: ما سوى الله ممكن، الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، وما سوى الله ممكن، هذه الحياة الدنيا كما هي عليه ممكنة، ويمكن أن تكون الدنيا من دون عمل، ولكن شاءت مشيئة الله عز وجل: أن كل شيء أودعه الله في الدنيا في الأرض من ثروات، يحتاج إلى عمل من قبَل البشر، فهذه المعادن التي أودعها الله في الأرض تحتاج إلى استخراج، تحتاج إلى تصفية من الشوائب، تحتاج إلى تصنيع، هذا الطعام الذي نأكله, يحتاج إلى أن تزرعه، وإلى أن تسقيه، وإلى أن تسمِّده، وإلى أن تعتني به، وإلى أن تفعل به كذا وكذا، إلى أن يصبح رغيف خبز، إذاً: ما من شيء خلقه الله سبحانه وتعالى, لن يصل إليك إلا بجهد بشري، هذا الجهد البشري أراده الله عز وجل ليكون -والعبارة دقيقة جداً - فرصة لك, لتعمل من خلاله العمل الصالح.
إذاً: أنت في حقيقتك مجموعة حركات، حركة، في عندنا صفة للأشياء سكونية، وصفة حركية، إما أن يبقى هذا الشيء في مكانه قابعاً إلى أبد الآبدين، نقول: هو سكوني، الإنسان طبيعته حركية، الإنسان موجود ليتحرك، أودع الله فيه الشهوات، ينطلق ليأكل، جعله الله يجوع، وهذا الجوع أحد الدوافع الكبرى لحركته في الأرض.
الآن: سيتحرك، في هذه الحركة؛ بإمكانه أن يكذب، وبإمكانه أن يصدق، في هذه الحركة؛ بإمكانه أن يخلص، وبإمكانه أن يخون، في هذه الحركة؛ بإمكانه أن ينصح، وبإمكانه أن يغش، إذاً: كل الذي تسعد به في الآخرة, لا يتبدى إلا من خلال حركتك.
لذلك هؤلاء الذين ينسحبون من الدنيا، يقبعون في صوامعهم، هؤلاء لا يرتقون إلى مستوى الذين خاضوا غمار الدنيا، وأطاعوا الله عز وجل، الذي يخالط الناس، ويصبر على أذاهم, خير من الذي لا يخالطهم, ولا يصبر على آذاهم.
إن الإنسان في جوهره وقت وحركة، في تحرُّك، العمل تحرك، مجيئك إلى هذا المسجد حركة، ذهابك إلى عملك حركة، مشروع زواجك حركة ، أي شيء تفعله هو تحرك فيه دوافع، الحاجات الأساسية التي أودعها الله فيك هي الدافع، ومن خلال هذه الحركة يكون العمل الصالح، ليس في الإسلام انسحاب من الحياة.
النبي عليه الصلاة والسلام حينما أمسك بيد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، رآها خشنة، فأمسك بها، وقال:
ومن أجمل ما اطلعت عليه: أن سيدنا عمر رضي الله عن عمر, إحدى جولاته التفقُّدية في بلاد المسلمين, رأى في مدينة أكثر التجار من الأقباط، فعنَّفهم تعنيفاً شديداً، هم ماذا قالوا؟ قالوا: ياأمير المؤمنين, هؤلاء لقد كفونا مؤونة العمل، فأدرك هذا الخليفة الراشد ذي البصيرة الحادة، أدرك أنك إذا انسحبت من الحياة, أصبحت عبداً عند هؤلاء الذين يعملون، قال: (
ببصره الثاقب رأى أن الحياة في جوهرها عمل، إنك ترقى بالعمل، ترقى بكسب المال، وترقى بإنفاق المال، وترقى بالتعامل مع المال، إذا قدَّمت عملاً جيداً فيه النصح، وفيه الإخلاص، وفيه الإتقان، وفيه الدقة، إن هذا مما يرفع من شأن المسلم، لذلك:
(( عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: لَيْسَ بِخَيْرِكُمْ مَنْ تَرَكَ دُنْيَاهُ لِآخِرَتِهِ ، وَلا آخِرَتَهُ لِدُنْيَاهُ حَتَّى يُصِيبَ مِنْهُمَا جَمِيعًا ، فَإِنَّ الدُّنْيَا بَلاغٌ إِلَى الْآخِرَةِ ))
كما قال عليه الصلاة والسلام:
﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ
هذه كلمةٌ عامةٌ شاملة؛ إتقانك لحرفتك من العمل الصالح، إتقانك لتصرُّفاتك التي تفعلها في رعاية من يلوذ بك من العمل الصالح، حسن الرعاية من العمل الصالح.
فيا أيها الإخوة الأكارم؛ ما من شيءٍ يظهر فيه الإنسان على حقيقته إلا هو العمل، يؤكد هذا الكلام: أن سيدنا عمر، وتعرفون هذه القصة، حينما سأل عن شاهد فقال:
من يعرف فلان؟ قال: أنا يا أمير المؤمنين، قال: هل سافرت معه؟ قال: لا، قال: هل جاورته؟ قال: لا، قال: هل حاككته بالدرهم والدينار؟ قال: لا، قال: أنت لا تعرفه
إذاً: متى يعرف الإنسان؟ من التعامل، من المجاورة، من الأخذ والعطاء، فالمقصود من هذا الكلام: أن المسلم يجب أن يكون متفوقاً في عمله، لأنه إذا تخلف في عمله بشكل أو بآخر, انحطت معنويات المسلمين، ما دام العمل يقوم به مسلم عملا غير متقن، أما ما دامت هذه الصنعة, صنعت في بلد أجنبي مثلاً كافر، إذاً: هي صنعة متقنة، أليس هذا مما يخدش سمعة المسلمين؟.
من هذا المنطلق: من أن الإنسان هو المخلوق الأول، وأن الله جاء به إلى الدنيا ليعمل، ليكون عمله زاداً له في سعادته الأبدية، هذا العمل لا يصلح إلا إذا عرف الله عز وجل.
(( الناس رجلان : بَرُّ تقي كريم على الله عزَّ وجل ، وفاجِر شقي هيِّن على الله عزَّ وجل ))
الحديث الأول من أحاديث هذا الباب:
(( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ, وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ))
العَرَض: المال، الإنسان يشعر بدافعٍ قوي, يدفعه إلى أن يكسب المال، فإذ جمع من المال ما شاء، لا يعد عند الله غنياً، هو غنيٌ بأعماله الصالحة، هذا الذي يؤكِّد المقدمة التي قلتها قبل قليل، هو غني عند الله بأعماله الصالحة, لا بماله، بمواقفه الشريفة، بعفَّته، بجوده، بكرمه، بمؤاثرته، هو غني عند الله بهذه النظافة الأخلاقية التي يتمتَّع بها.
لذلك كما قال سيدنا علي كرم الله وجهه:
﴿ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ
النبي عليه السلام حينما دعا ربه فقال:
والعمل لن يصيب الهدف من دون علم، العلم مقدَّمٌ على العمل، لأن الحركة من دون علمٍ حركة طائشة، حركة غير صائبة، حركة غير مجدية، حركة عشوائية، حركة من غير جدوى، لكن العلم إذا سبق العمل يسدد العمل، والعمل نفسه يعمِّق العلم، فهناك علاقة ترابطية بين العلم وبين العمل، كلما ازددت علماً ازددت في الحركة صواباً ، وكلما ازددت صواباً
أن تزداد علماً: قال تعالى :
﴿ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ
﴿ أَمْ مَنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ
القيمة الوحيدة المرجِّحة التي أقر الله بها في القرآن: هي العلم.
وأما العمل :
هذه الأعمال أولها: أن تكون أباً كما أراد الله، إذا كنت أباً، إذا كنت ابناً، أن تكون ابناً كما أراد الله، إذا كنت جاراً، أن تعامل جارك كما أراد الله، فأولاً بُنيتك الأساسية يجب أن تؤديها كما أراد الله.
الآن: عملك، مهنتك، هناك مسلمون كثيرون, يعزفون عن إتقان أعمالهم، ويعزفون عن التفوِّق فيها، بمنطلق غير صحيح, هو أن هذه الدنيا ظل زائل، صحيح هذا, ولكنك بها ترقى، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال:
(( لا تسبوا الدنيا، فنِعم مطية المؤمن ))
أنت بالدنيا ترقى إلى الله، أنت بالعمل تكسب المال، بهذا المال تنفقه، بإنفاقك إياه ترقى عند الله، أنت لك حرفة، إذا خدمت بها المسلمين, ارتقيت إلى الله عز وجل، عندك خبرة، عندك قوة، عندك جاه، عندك علم، أي شيء تنفقه ترقى به، لذلك في سورة البقرة في مطلعها, يقول الله سبحانه وتعالى:
﴿ الم (1) ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ (2) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (3)﴾
لذلك الإمام الشافعي قال:
ليتك تحلـو والحيـاة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب
إذاً: المؤمن حينما يستيقظ صباحاً، أمامه هدفان كبيران؛ أن يزداد علماً، وأن يزداد عملاً صالحاً، صار الانسحاب من الحياة, لا يتناسب مع هذه العقيدة، الانسحاب من الحياة، الهروب، الانزواء، التقوقع، الانعزال، البُعد، عدم إتقان الأعمال، التواكل، التسيُّب، الإهمال، هذا كله ليس من صلب الدين، مما طرأ على الدين، والدين منه براء.
(( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ, وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ))
ما الذي يجعلك غنياً؟ معرفتك بالله عز وجل، أعمالك الصالحة، هذه المقولة أقولها دائماً, والتكرار في بعض الأحيان مفيد, قال تعالى:
﴿ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ (55)﴾
كل إنسان له عمل, إذا ابتغى به وجه الله، وابتغى به خدمة المسلمين، وابتغى به أن يكفي نفسه وأهله، وكان في الأصل مشروعاً، ومارسه بطريقة مشروعة، ولم يشغله عمله عن طاعة, أو عن مجلس علم، هذا العمل نفسه عبادة، قد تلقى الله بمهنتك، قد تلقى الله إذا كنت طبيباً مخلصاً، أو محامياً مخلصاً، أو مدرساً مخلصاً، أو موظفاً مخلصاً، أو تاجراً نصوحاً، أو صانعاً متقناً، إتقان الصنعة جزء من الدين، هذا كله قد يجعلك من الله قريباً
الآن: بربكم لو أن أحدكم جاءته رسالة، من دون أن يفتحها، من دون أن يقرأها، من دون أن يفهمها، من دون أن يقف عند مضامينها، مزَّقها، وألقاها في سلة المهملات، ألا يعد هذا مجنوناً؟! اقرأها، وبعد أن تقرأها, إن رأيتها سخيفة فألقها، لكن أنت كإنسان, جاءك خطاب؛ لا من صديق، ولا من زميل، ولا من قريب، جاءك خطاب من رب السموات والأرض، ألا ينبغي بادئ ذي بدء: أن تقرأ هذا الخطاب؟ أن تقرأه، وأن تستوعبه، وأن تفهمه ، وأن تتدبره، بعدئذٍ أحكم عليه، هذا الذي يحكم على الأشياء قبل أن يطلع عليها، إنسان في أحط درجات الجهل.
ما الشيء الذي يشغلك عن معرفة كتاب الله؟ هل في كل حياتك، هل في كل نشاطاتك، هل في كل أعمالك, شيء يفوق أن تعرف منهجك، وطريق سعادتك؟ لا والله.
لذلك: العلم والعمل، الغنى أن تعرف الله، الغنى أن تعرف أمره، الغنى أن تكون مستقيماً على أمره، الغنى أن يكون لك عند الله, رصيدٌ كبير من الأعمال الصالحة، هذا الغنى، بهذا افتخر، لهذا اسعَ، في هذا الحقل تنافس، في هذا الحقل تسابق مع أخوانك، في هذا الحقل, هنا البطولة، أما في مجال آخر: إنها معركة خاسرة, ولو كنت فيها فائزاً، إنها معركة لا قيمة لها, ولو تفوَّقت بها على خصمك، لأن الدنيا جيفة طلابها كلابها، والدنيا دار من لا دار له، ولها يسعى من لا عقل له، لكن إذا أحسنت صنعك، أحسنت عبوديتك لله عز وجل، الله سبحانه وتعالى وعدك بنص القرآن الكريم, أن يوفقك في أعمالك، وأن ييسر لك أمورك
لذلك الإمام ابن عطاء الله قال:
فقد يكون المنع عين العطاء، وقد يكون العطاء عين المنع، هذا الحديث يمكن أن يكون شعاراً لكل مؤمن
انطلاقاً من هذه المقدمة التي تؤكد قيمة العلم والعلم، انطلاقاً من هذه المقدمة التي تؤكد جوهر الإنسان، أنت أيها الإنسان المخلوق الأول، الذي سخر الله له السموات والأرض، أنت المخلوق الوحيد المكلَّف، أنت المخيَّر، أنت الذي أودع الله فيك الشهوات، لترقى بها صابراً أو شاكراً إلى رب الأرض والسموات، أنت الذي أودع الله فيك العقل, ليكون ميزاناً لمعرفة الأشياء، أنت الذي أعطاك الله فطرة عالية .
انطلاقاً من هذه المقدمة التي تؤكد هوية إنسان، وقيمة العلم والعمل.....
الحديث الثاني من أحاديث هذا الباب:
عن حكيم بن حزام رضي الله عنه, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال, الحديث متفق عليه, قبل أن نقرأه، ومعنى متفق عليه: أن الشيخين الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهما الله تعالى اتفقا عليه، وأعلى أنواع الحديث الصحيح ما اتفق عليه الشيخان، ثم ما انفرد به البخاري، ثم ما انفرد به مسلم، ثم ما ورد في الكتب الصحاح الست، فإذا قلت: متفق عليه, يجب أن تكونوا في مستوى, قول سيدنا سعد رضي الله عنه, حينما قال:
(( عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى, وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ, وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى, وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ, وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ ))
في حديث آخر:
(( عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ, وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ وَالْمَسْأَلَةَ، الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى، والْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ، وَالسُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ ))
فالعليا، النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، وكلامه أفصح كلام بعد كلام الله عز وجل، اليد العليا؛ لذلك بعض الصالحين: كان إذا وضع الصدقة في يد الفقير, يضعها هكذا من تحت، ليكرم هذا الفقير, ويجعل يده هي العليا، هذا تأدُّب مع الفقير، لأن هذا الفقير الذي قبل أن يأخذ منك, له فضل عليك.
أحياناً في حالات نادرة، تندفع اندفاعاً شديداً إلى إكرام إنسان، لا يرضى، لا يقبل، حينما رفض هذا العطاء, منعك من هذا العمل الصالح، فهذا الذي يأخذ منك, له فضلٌ عليك، لأنه سمح لك, أن تتقرب إلى الله عز وجل، فكان السلف الصالح يعطي الصدقة هكذا، ولكن الحقيقة: العليا هي المنفقة المعطية، والسفلى هي الآخذة السائلة
(( عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ))
لك مركز قوي, لجأ إليك أخ، هذا الأخ أكرمته، أما إذا كان الإنسان ضعيفًا, لا يستطيع أن يفعل شيئاً، لا يستطيع حَراكاً، يحتاج لمن يعينه، هو مؤمن وهذا جيد، ونحن نريد ذلك، ولكن ليته كان قوياً، كلمة قوة: ماذا تعني؟ هل تعني مصارع؟ لا، القوة مطلقة، ماذا قال الله عز وجل؟ قال سبحانه:
﴿ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى (5)﴾
القوة: التمكُّن من الشيء، هناك قوة في العلم، قال تعالى:
﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكاً قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ
هناك قوة في العضلات، رياضي، أحد الأشداء الأقوياء المصارعين، قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إن صرعتني أؤمن بك, فصرعه النبي أول مرة، وثاني مرة، وثالث مرة، واحد في أثناء بعض المعارك قال: أين محمد؟ لا نجوت إن نجا, فالنبي حينما سمع مقالته هذه, قال: دعوه، لم يرض أن يقف مكانه أحد، أمسك النبي الكريم الرمح، وكزه به وكزةً، فانقلب من على فرسه, يعوي كالكلاب، وقال: محمد قتلني, قالوا: ما قتلك, قال: والله لو بصق علي لقتلني
درهم تنفقه على فقير، درهم على مسكين، ودرهم تنفقه على أهلك، هذا الدرهم, أحب إلى الله تعالى من كل هذه الدراهم
لماذا؟ لأن هذا الفقير أو المسكين, إن لم تعطه أنت, أعطاه غيرك، أما أهلك ليس لهم أحد سواك:
(( وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ ))
من هنا قال عليه الصلاة والسلام:
(( ليس منا من وسع الله عليه, ثم قتر على عياله ))
(( وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ, عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ, وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي ))
وحينما ضم النبي عليه الصلاة والسلام ابنته السيدة فاطمة رضي الله عنها, حينما ولدت، قال عليه الصلاة والسلام معلماً لنا، قال:
(( ريحانة أشمها, وعلى الله رزقها ))
فالتفاؤل والاستبشار والمؤانسة، وأن تكون بساماً ضحاكاً، أن تكون عفواً كريماً، أن تكون حليماً في بيتك، المرأة والصغير ضعاف, مَن لهم غيرك؟
﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً (29)﴾
﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً (67)﴾
إذًا:
السيدة عائشة قالت له: يا رسول الله, لم يبق إلا كتفها, فقال عليه السلام:
سيدنا الصديق أعطى كل ماله، قال له :
هذا التوجيه يسع الناس جميعاً، في مواقف أحياناً للصحابة, هي مواقف رائعة جداً، ولكن ليست حكماً شرعياً، مواقف خاصة، حالة من حالات القرب والصفاء، والإخلاص والفناء في حب الله، حملته على أن يفعل هذا، فالتقليد صعب، لو الإنسان قلد، وبعد التقليد شعر بالحرمان، وعرج، وندم، ويئس، فأصعب شيء: أن تندم على عمل صالح، كأنك ما عرفت الله عز وجل, حينما فعلت هذا من أجله، هذا معنى:
(( عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِحْصَنٍ الْخَطْمِيِّ, عَنْ أَبِيهِ, وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ, مُعَافًى فِي جَسَدِهِ, عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ, فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ ))
العدل حسن, لكن في الأمراء أحسن، وأن السخاء حسن, ولكن في الأغنياء أحسن، وأن التوبة حسن, لكن في الشباب أحسن، وأن الحياء حسن، ولكن في النساء أحسن، وأن الصبر حسن، ولكن في الفقراء أحسن.
فالعفة صفة رائعة جداً، ماذا قال سيدنا جعفر, حينما حدَّث النجاشي؟ قال:
(( الإيمان عفيف عن المحارم، عفيف عن المطامع ))
المحارم التي نهى الله عنها, والمطامع, الأشياء المباحة, لكن تحتاج إلى أن تريق ماء وجهك.
فهنا:
اجعل لربك كل عــزك يستقر ويثبـت
فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت
قــل لمن بات لي حاسداً أتدري على من أسأت الأدب؟
أســأت على الله في فعله إذ لــم ترض لي مـا وهب
ملك المـــلوك إذا وهب قم فاســــألن عن السبب
الله يعطـــي من يشـاء فقف علـــــى حد الأدب
فاجعلها مع الله عامرة، هكذا الله عز وجل قال، كما في الحديث.
(( فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا مَضَى شَطْرُ اللَّيْلِ أَوْ ثُلُثَاهُ, يَنْزِلُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا, فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ سَائِلٍ يُعْطَى؟ هَلْ مِنْ دَاعٍ يُسْتَجَابُ لَهُ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ يُغْفَرُ لَهُ؟ حَتَّى يَنْفَجِرَ الصُّبْحُ ))
باب الله مفتوح، باب مفتوح، قيام الليل وقت مناسب, لطلب الحاجات من الله عز وجل، سيدنا زكريا, قال تعالى:
﴿ إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيّاً (3) قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيّاً (4)﴾
ما دعوتك يا رب مرة إلا وأكرمتني:
الله عـــودك الجــــميل فقس علـــى ما قــد مضى
ورب ضـائقة يضيق بها الفتى ذرعــاً وعند الله منها المخرج
نـزلت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظن أنـها لا تفرج
﴿
فإذا كنت في رضى الله عز وجل, فأنت من أغنى الأغنياء، وكفاك على عدوك نصراً, أنه في معصية الله، والدنيا زائلة, قال تعالى:
﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (26) وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (27)﴾
قصة سيدنا حمزة رضي الله عنه:
والآن إلى متابعة قصة سيدنا حمزة رضي الله عنه, عم النبي عليه الصلاة والسلام.
في الدرس الماضي:
عرفتم كيف أن الصحابي الجليل, عم النبي عليه الصلاة والسلام، كان من ألمع رجالات قريش، كان ثاقب العقل، كان راجح العقل، ثاقب النظر، كريم النفس، من أصحاب المروءات، حينما بلغه أن أبا جهل, تهجم على النبي عليه السلام، وأقذع عليه في الشتم، انهال عليه ضرباً، وفي ساعة حميَّةٍ ومروءة، قال:
أتسبه وأنا على دينه؟
فقد أسلم ارتجالاً، فهؤلاء الذين حول أبي جهل, قالوا:
يا حمزة, ما نراك إلا قد صبوت!.
أنت أسلمت، حتى أنت يا حمزة أسلمت.
قال: ومَن يمنعني، وقد استبان لي منه؟ أشهد أنه رسول الله.
وأنت أيها الأخ الكريم؛ إذا اقتنعت أن الدين حق، لماذا خائف من الناس؟ حتى لا يقولون عني شيخ, إذا كان الله عز وجل هو الحق المبين، والطريق إليه واضحة وسالكة، وفي هذا الدين, السعادة في الدنيا والآخرة، أتخشى الناس؟ أتخشى أقرباءك؟ أتخشى أخوانك؟ أتخشى من حولك؟ أتخشى من فوقك؟ أتخشى من دونك؟ أتخشون الناس والله أحق أن تخشوه؟ قال تعالى:
﴿
قال: ومن يمنعني, وقد استبان لي منه؟ أشهد أنه رسول الله، وأن الذي يقول: هو الحق، فو الله لا أنزع، فامنعوني إن كنتم صادقين.
إنه التحدي، كان سيدنا حمزة من كبار قريش، أعز الله به الإسلام وبعمر أيضاً.
أبو جهل حينما تلقى منه ضربة شديدة، كاد ينشب خلافٌ وتهجم على سيدنا حمزة، فوقف أبو جهل, وقال: دعوا أبا عمارة، فإني والله لقد سببت ابن أخيك سباً قبيحاً، أنا الحق علي، اعترف بذنبه، ثم رجع حمزة إلى بيته، ولكن ما له يفكر.
أحياناً: الإنسان يقع بإشكال, تجده ساهيًا، أحياناً يصلي, يقرأ التحيات لله, وهو واقف ، ثم يرفع إصبعه هكذا، فما هذه الحركة؟! ولكن ما له يفكر، ويفكر تفكيراً عميقاً, يشغل عليه نفسه، ويمر الليل عليه, ولم يذق فيه للنوم طعماً، هو تصور نفسه, أسلم ارتجالا، وانفصل عن مجتمعه، وترك دين آبائه وقومه، وصار منبوذ عند قومه، وشعر بوحشة، النقلة من دين إلى دين ليست سهلة, وها هو الشيطان يحدثه: أنت سيد قريش.
أحياناً: الإنسان تأتيه خواطر شيطانية، وخواطر رحمانية، أذن الظهر، فيقول له: لا تصل، فسيعرفونك صاحب دين، هذا من الشيطان، امرأة تريد أن تصافحك، فيقول لك: صافحها, لكي لا تحرج أمامها، زوجها له وظيفة كبيرة، يمكن أن يزعجك, لا أنت سيد قريش، هكذا قال له الشيطان، اتبعت هذا الصابئ، وتركت دين آبائك، للموت خير لك مما صنعت، دخل الوسواس.
أحياناً: الإنسان يختار زوجة لدينها، متى ما قرؤوا الفاتحة, تجده قد كنّ، وسكن، فلا ينام ليلتها، فإذا قال الله عز وجل:
﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ
إذا كان عملك عملته لله, فلماذا أنت خائف؟ قال تعالى:
﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (175)﴾
أقبل حمزة على نفسه يقول: ما صنعت يا حمزة؟! ليس له إلا الله، قال: اللهم إن كان رشداً ما فعلت، فاجعل تصديقه في قلبي، أرحن يا رب، أنا قلق، في تمزق، في صراع، وإلا فاجعل لي ما وقعت فيه مخرجاً, أنسحب من هذا الإسلام الذي أسلمته, إذا كان خلاف الحق, الأمر اشتد، تفاقم الأمر معه-, حتى غدا إلى النبي عليه الصلاة والسلام.
قال له: يا بن أخي, أقبل عليه خاشعاً، رأى في عينيه نوراً, يقذف في قلبه، ويقيده، فلا يستطيع فكاكاً، ما هذه القوة في عيني النبي عليه الصلاة والسلام؟ تقدم إليه- وقال: يا بن أخي, إني قد وقعت في أمر، ولا أعرف المخرج منه.
بالمناسبة يا إخوان: الإنسان قوي بإخوانه، إذا وقع بشدة، وله أخ كريم يثق بإيمانه، وبإخلاصه، برجاحة عقله، إذا بقي وحده، فالشيطان يقوى عليه، وأعوان الشيطان، الله عز وجل ماذا قال؟ قال:
﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
إذا فعلت عملا صالحًا، وندمت عليه، وشعرت بخطر، وكأنك تورطت، وذهبت سألت واحداً من أهل الدنيا، فسيقول لك: أصلحك الله، ألم أقل لك: لا تفعل ذلك؟ أول شامت بك، يشمت فيك، يخوفك، إياك، هذه لها مضاعفات خطيرة جداً، الله يصلحك، أخطأت، دمرت نفسك فيها، إياك أن تسأل أهل الدنيا بأمرٍ فعلته لله، إياك أن تستشيرهم، إياك أن تلتمس عندهم الطمأنينة، إياك أن تلتمس عندهم النصيحة, لا ينصحونك, قال تعالى:
﴿ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً
وارجع لأهل الإيمان يطمئنونك: لا تحزن، لا تخف، الله معك، هذا العمل طيب، الله عز وجل لن يضيِّعك، لن يتخلى عنك، سينصرك، التمس النصيحة عند أهل الإيمان، التمس الطمأنينة عندهم.
فقال للنبي عليه السلام: يا بن أخي, إني قد وقعت في أمر، ولا أعرف المخرج منه، وإقامة مثلي على ما لا أدري ما هو، أرشد أم غي شديد؟.
أنا الآن لست متأكداً من هذا الذي فعلته البارحة، رشد أم غي؟ أحسنت صنعاً, حينما آمنت وأسلمت؟ اللهم صل عليه، سجل هذه السابقة لسيدنا الصديق، ولم يسجلها لأحد غيره، قال:
(( ما دعوت أحداً إلى الإسلام, إلا كانت له كبوة، إلا أخي أبا بكر ))
النبي عليه السلام أقبل عليه، ذكره بالله، وعظه، خوَّفه، بشَّره، سمع حمزة هذا وبكى، واطمأن قلبه، واستنار قلبه، فإذا وقعت في حيرة، أو بمشكلة، استخر الله عز وجل: يا رب إن كان في هذا الأمر خيراً لي في ديني ودنياي، وعاجل أمري وآجله, فاقدره له، إذا في خلاف ذلك, فاصرفني عنه, واصرفه عني.
سيدنا حمزة بعد أن سمع النبي عليه الصلاة والسلام يطمئنه، ويذكره، ويخوفه، ويعظه، ويبشره، قال: أشهد إنك صادق، شهادة الصدق، فأظهر يا بن أخي دينك، فو الله ما أحب أن لي ما أظلته السماء, وأنا على ديني الأول، أظهر دينك، وأنا معك, وما أحب أن لي ما أظلته السماء -كل شيء يعني، وأنا على ديني الأول.
كان في هذا الإسلام عزاً للإسلام كبير، هو أسلم قبل سيدنا عمر، سيدنا عمر حينما أسلم, وتوجه إلى النبي عليه السلام ومعه سيفه، ورآه أحد أصحاب النبي في دار الأرقم مقبلاً ومعه السيف، ظن أن هذا الرجل الشديد, جاء يريد شراً، فرجع الصحابي إلى النبي عليه السلام، وهو فزع فقال: يا رسول الله, هذا عمر بن الخطاب متوشحاً السيف.
هنا قام حمزة الأسد قائلاً: فأذن له، فإن جاء يريد خيراً بذلنا له، وإن جاء يريد شراً قتلناه بسيفنا.
أيها الإخوة؛ ما عاد حمزة، صار حمزة آخر الآن، الآن باع كل شيء في سبيل الله.
هجرته إلى المدينة:
أيها الإخوة؛ حينما هاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام, نزل في المدينة فقيرا، لا يملك من الحياة شيئاً غير إيمانه، فمن كان غنيًا نحن أم هو؟ إذا كان مع واحد قرشان أو ثلاثة الآن، هو أغنى أم هذا الصحابي الجليل؟ إن الغنى غنى النفس، هذا الموقف الشريف، هذه القوة في الحق، هذه الشهامة، هذه المروءة، هذا هو الغنى.
سيدنا النبي عليه السلام آخاه مع عبدٍ رقيق من المسلمين، وقبل هذا الصحابي الجليل أن يكون أخاً لسيدنا زيد بن حارثة، فتآخيا اثنينِ اثنين.
وهذه نصيحة لكل إخواننا، إذا كان كل أخ منكم, له أخ في الله، فقال: أنا فلان أخي، حاول يتفقده، إذا كان مرض، عاده، غاب عن الدرس، زاره في البيت، أصابه خير هنأه، وقع بمشكلة عاونه، إذا كل أخ اختص بأخ, يكون طبقنا الحديث الكريم: تآخيا اثنينِ اثنين، في معركة بدر الشهيرة، خرج منها الأسود بن عبد الأسد المخزومي، وكان رجلاً شرساً, سيء الخُلُق، فقال وقد بنى المسلمون حوضاً:
أعاهد الله لأشربن من حوضهم، أو لأهدمنه، أو لأموتن دونه، فلما خرج ليشرب من هذا الحوض وهو عند المسلمين، خرج إليه حمزة بن عبد المطلب، فلما التقيا, ضربه حمزة قاطعاً قدمه إلى نصف ساقه، وهو دون الحوض، وقع على ظهره، تشخب رجله دماً، ثم حبا إلى الحوض, حتى اقتحم فيه، يريد أن يبر بيمينه، واتبعه حمزة, فضربه حتى قتله.
ثم نادى مناد قريش: يا محمد, أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا، فقال عليه السلام: قم يا عبيدة بن الحارث، قم يا حمزة، قم يا علي، إلى أين يقومون؟ لتناول طعام الغداء؟ إلى أن يضعوا أرواحهم على أكفهم؟ قاموا ليموتوا، والجود بالنفس أقصى غاية الجود، فأعلى درجة بالإنسان، أعلى عمل صالح يفعله: أن يقدم نفسه- وصاح عتبة بن ربيعة: من أنتم؟ فأجابه حمزة: أنا حمزة أسد الله, وأسد رسوله.
وتبارزوا، فقتل حمزة وصاحباه المشركين، ثم تزاحف الجمعان، وثار النقع، وحمزة كالسيل يهجم يميناً وشمالاً، وينتقل من مكان إلى مكان، فيفتك بالمشركين فتكاً ذريعاً، فتنهار الكتائب، ويفزع صناديد قريش، ويختلط حابلهم بنابلهم، ويولون الأدبار, وقد ضربت عليهم الذلة والمسكنة.
أسر أمية بن خلف، أسره عبد الله بن مسعود، فبينما هما يسيران، قال أمية:
يا عبد الله، من هذا الرجل الذي علَّم نفسه بريشة نعامة؟ -وضعها على صدره, من هذا؟- فقال: ذلك حمزة بن عبد المطلب, فقال: ذلك الذي فعل فينا الأفاعيل!؟
فقد كانت له مواقف في بدر مشهودة، بل ربما كانت هذه المعركة, في معظم انتصاراتنا, بفضل هذه الشجاعة الخارقة، وهذا البذل الغير محدود.
ولكن شاء الله عز وجل أن يقع هذا الصحابي، عم النبي عليه السلام، أن يقع شهيداً، وأن يسميه النبي عليه السلام: سيد الشهداء، هكذا شاءت مشيئة الله.
استعد القرشيون للقتال في العام التالي، وقبل أن يسير المشركون إلى القتال، دعا جبير بن مطعم غلاماً, يقال له:
وحشي, يقذف بحربةٍ له قذف الحبشة، فقد كان ماهراً في قذف الحراب، قلما يخطئ، فقال له: اخرج مع الناس، فإن أنت قتلت حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام بعم طعيمة بن عدي, فأنت عتيق، يبدو أن هذا الصحابي الجليل عم النبي عليه الصلاة والسلام, ما كان أحد يستطيع أن يواجهه، ولا سبيل إلى قتله إلا غيلةً.
ثم خرجت قريش بحدِّها وحديدها، وجدها وأحابيشها، ومن تابعها من بني كنانة، خرجوا معهم النساء, التماس الحفيظة لئلا يفروا، وخرج أبو سفيان, ومعه امرأته هند بنت عتبة، وكانت كلما مرَّت بوحشي أو مر بها, قالت له: أبا دسمة اشف واشتهِ، -أي اشفِ غليلنا- وخذ ما تشتهي.
أي العتق.
و الحمد لله رب العالمين