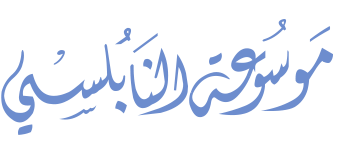الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.
أيها الإخوة الكرام؛ مع الدرس التاسع والسبعين من دروس مدارج السالكين، في منازل إيّاك نعبد وإيّاك نستعين، ومنزلة اليوم منزلة الرغبة، قال تعالى:
﴿ عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ (32)﴾
قال تعالى:
﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ (90)﴾
ما من منزلةٍ من منازل مدارج السالكين إلا ولها أصْلٌ في الكتاب الكريم، أو سنّة النبي عليه أتمّ الصلاة والتسليم، فالله سبحانه وتعالى يقول: ﴿وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً﴾ ولابدّ من وقْفةٍ متأنية عند هذه الآية.
من السَّهل أن ترجو رحمته دون أن تدفع الثَّمَن، ومن السَّهل أيضًا أن تقنط من رحمته لِجَهلٍ مُسْتحْكِم، لكنّ البطولة أن تعبُدَهُ راجيًا وخائفًا، راغبًا وراهبًا، رغبةً ورهبةً، الوضْع المتوازن يحتاج إلى بطولة، أما التطرّف فسهلٌ جدًّا، أبٌ بإمكانه أن يكون سهلاً فَيُعْصَر، وبإمكانه أن يكون عنيفًا جدًّا، كلا الحالتين سهلةٌ على الأب، إما أن يُسيب وإما أن يبطش، أما الأب الذي يرجو أولاده عطاءه، ويخافون غضبهُ في الوقت نفسه هذا أب مُرَبٍّ حكيم، بالمقابل المؤمن الصادق يعبد الله رغبًا ورهبًا، إذا عرف من رحمته لا يطمع بها فَيُقصِّر، وإذا عرف من عقابه لا يدْفعُه العقاب إلى أن ييْأس، أكمل موقف قاله سيّدنا عمر: والله لو علمْتُ أنّ الله معذِّبٌ واحدًا لَخِفْتُ أن أكون أنا، ولو علمْتُ أنّ الله راحم واحدًا لرجَوْتُ أن أكون أنا.
الفرق بين الرغبة والرجاء:
لكنّ العلماء فرَّقوا بين الرغبة والرجاء، قالوا: الرّجاء طمع والرغبة طلب، طمعٌ وطلبٌ، أو الرجاء ثمرةُ الطَّمع، تطْمعُ فترْغَب، فإنَّه إذا رجا الشيء طلبهُ، والرغبة من الرَّجاء كالهرب من الخوف، فمن رجا شيئًا طلبه ورغب فيه، ومن خاف شيئًا هرب منه.
أيها الإخوة؛ الإنسان يطمع فيرغب فيطلب، يخاف فيهرب، هذا يقودنا إلى قانون، قانون التعامل مع المحيط، الإنسان في تعامله مع المحيط يسْلُك القانون التالي: يُدْركُ فيَنْفَعِل فيَسْلُك فيتحرّك، أوْضَحُ مثلٍ: كنتَ في بستانٍ، رأيْتَ أفعى، انطبع شكلها على شبكيّة العين، إحساس، انتقَلَتْ هذه الصورة إلى الدّماغ؛ إدراك، بِحُكم المفهومات التي تعرفها في المدارس، ومن خلال التعامل الاجتماعي أنّ فلاناً لدَغَتْهُ الأفعى فمات، الأفعى سمُّها قاتل، وهناك أفعى خطيرة جدًّا، وهناك ثعبان مبين، معلومات وصَلَت إليك فكوَّنَتْ مفاهيم، فهذه الصورة حينما تنتقل إلى الدّماغ تصبحُ مفهومًا مُدْركًا، الإدراك لا يمكن إلا وأن يُحْدث اضطراباً، ما دامَتْ أفعى وهي قريبة منك، وهناك خطر أن تلدغكَ فلابدّ من أن تضطرب، علامة صحَّة الإدراك الاضطراب، وعلامة صحّة الاضطراب السلوك، إما أن تقتلها وإما أن تهرب منها، إدراك انفعال سُلوك، فإن لم يصحّ الإدراك لا يكون انفعال، وإن لم يكن هناك انفعال ليس هناك سلوك.
مثلاً لو أنَّ واحدًا قال للآخر: انتبِه يوجد على كتفك عقرب، بقي مرتاحاً، هادئاً جدًّا، التفت نحوه، وابتسَم، وقال له: أنا شاكر لهذه الملاحظة، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يمكِّنَني أن أكافئك عليها، هذا الموقف الهادئ جدًّا والبسيط وإزجاء عبارات الشكر، هل معنى ذلك أنّ الذي سمع كلمة عقرب فهمها؟ لم يفهمها إطلاقاً، إدراك انفعال سلوك، هذا هو القانون، ومن ألطف ما في الأمر أنَّ النبي عليه الصلاة والسلام قال:
(( عن عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ مُقَرِّنٍ، قَالَ: دخلتُ مع أبي وأنا إلى جنبِهِ عند عبدِ اللهِ فقال لهُ أبي : أسمعتَ من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ؟ فقال : نعم سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ : الندمُ توبةٌ ))
[ أخرجه الحاكم وابن ماجه وأحمد ]
التوبة تحتاج إلى علم، وإلى حال، وإلى سلوك، فالنبي اختصر بالنَّدم، بالحال، شُرّاح الحديث قالوا: هذا الحال يوجبهُ علم، وينْتُجُ عنه سُلوك، هذا الحال له سبب، وله نتيجة، سببه العلم، نتيجته السُّلوك، فالراجي طالب، والخائف هارب، والدليل قوله تعالى:
﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (110)﴾
علامة صِدْق الرّجاء العمل، الله عز وجل ربط الرجاء بالعمل، ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ﴾ .
﴿ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا (19)﴾
أي بِشَكلٍ أو بآخر: إن لم يُتَرجم العلم إلى عمل لا قيمة له، إن لم يُتَرجم الإيمان إلى سلوك فلا قيمة له، إن لم يُترْجم التوحيد إلى تقوى لا قيمة له:
وعالم بعِلْمه لم يعملَن مُعَذَّبٌ من قبل عبّاد الوثن
الراجي طالب، والخائف هارب، والحقيقة الرغبة هي الرجاء حقيقة، الرجاء طمَع يحتاج إلى تحقيق، طمعٌ في مُغيَّبٍ عنك، مَشْكوك في تَحصيله، وإن كان مُتحقِّقًا بِذاته، الجنّة مُتحقِّقة بذاتها، لكن القلق أن يُسْمحَ لي أن أدخلها أو ألا أدخلها.
لا تقلق على الإسلام إنّه دين الله:
بالمناسبة الشيء بالشيء يُذْكر، الإنسان أحيانًا يستمع إلى الأخبار، يتوهَّم أنَّ الإسلام انتهى، الإسلام يواجه معركة مصير في أي مكان في العالم، في شمال الأرض وجنوبها، وفي شرقها وفي غربها، أعداء المسلمين أقوياء وأشِدَّاء وقُساة، ويرَوْن الإسلام عدُوًّا لهم لدودًا، أنا أُجيب عن هذا التساؤل وعن هذا الشعور غير السوي: لا تقلق على الإسلام إنّه دين الله، الله بيَدِهِ كلّ شيء، هؤلاء الأعداء الألداء كُنْ فيكون، زُلْ فيَزُول، أضربُ لكم مثلاً: في بعض الروافع الكهربائيّة في معامل الحديد ترفع عشرين أو ثلاثين طنًّا عن طريق الكهرباء، كلّكم يعلم أنّ الكهرباء تُشكِّل مساحة مغناطيسيّة، فإذا أحطْنا سطح الرافعة بِوَشيعة كهربائيّة، يصبح فيها قوّة جذب كبيرة جدًّا، فقد تحمل هذه الرافعة عشرين طُنًّا، ولا يستطيع أقوى الرّجال أن يأخذ منها قطعة واحدة، أما عامل هذه الرافعة لو ضَغَط الزرّ ربع ميلي لسقَطَ كلّ ما عليها، قطَعَ الكهرباء، انتهى المغناطيس، وقع كلّ الحديد، أقوى قوّة في الأرض لو أراد الله عز وجل تدميرها لقال: كُن فيكون، زُل فيَزُول، قال تعالى:
﴿ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ (74)﴾
أقرب مثل زلزال تركيا الأوّل والثاني، الثاني أيضاً زلزال كبير جدًّا، ذهب ضحِيَّته مئات القتلى، وآلاف الجرحى، وعشرات ألوف المُشرَّدين، هم يبْنون السُّدود لِيَمْنعوا الماء عنَّا، الخبراء قالوا: لابدَّ من تفريغ السُّدود، وإلا كانتْ طامّة كبرى، وأُفْرِغَت السُّدود، وانتقلت المياه إلى أصحابها قهْرًا، الله عز وجل قهَّار، فالراجي طالب، والخائف هارب، والرغبة هي الرّجاء بالحقيقة، والرجاء طمعٌ يحتاج إلى تحقيق، أيْ طمعٌ في مُغَيَّبٍ عن الراجي مَشكوك في تحصيله، وإن كان متحقِّقًا في ذاته كالجنّة هي مُتَحَقِّقة، ولكنّ القلق أن يُسْمح لنا بِدُخولها أو ألا يُسْمح.
النُّقْطة الدقيقة جدًّا جداً في الدرس: متى تتولَّد الرغبة؟ إنسان عندهُ محلّ، يبيع بضاعة بالمفرق، وهذا المحلّ يُعجبه، وهو قرير به عيناً، جاءهُ إنسان قال له: لو عملت مكتب استيراد، تبيع زبوناً واحداً، وتربح عشرة أضعاف ربْحك الحالي مثلاً، وإن كان العكس هو الصحيح، لم يعُد هناك ربحاً الآن، فرضاً أنت تداوم ساعتين بمكتب وتربح أرباحًا طائلة ومكانتك عالية، ولا علاقة لك بالتعامل اليومي مع الزبائن، فهذا صاحب المحلّ المفرق لمّا سمع هذا الكلام رَغِب أن يكون بائع جملة أو مُسْتوْرِداً، متى تولَّدَت الرغبة؟ من الإدراك، العلم، فأول نقطة في الدرس وأخطر نقطة لا يمكن أن تتولّد لك رغبة في الدار الآخرة، ولا في السّعي إلى الجنّة، ولا في طاعة الله، إن لم تعْلَم، العِلْم أساس، بالمقابل كما أنّه لا يمكن أن ينشأ لدَيْك خوفٌ حقيقيّ من مَعْصِيَة إلا إذا أدْركْتَ ماذا تعني المعصِيَة، تعني حجابًا عن الله عز وجل، بل إنّ أشدّ عِقابٍ يُعاقبُ به الإنسان كما قال تعالى:
﴿ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ (15)﴾
الحِجاب، فأنت تُطيع بِقَدْر عِلْمِك، وتنتهي عن مناهي الله بِقَدر علمك، فالعلم يُوَلّد الرغبة في العمل، والرغبة في التَّرك، مثلاً إنسانٌ يُدَخِّن، تقول له: يا أخي، الدخان قد يُسبّب سرطاناً، الدخان قد يُسبّب أزمة قلبيّة، يُسبب جلْطة، يُسبّب داء الغرغرين المُوات، تأتيه بالأدلّة القاطعة، والبُحوث العِلميّة الجامعة، والحقائق الناصِعَة، ومع ذلك يُدَخِّن، أما حينما يُصاب فعلاً في قلبهِ، أو بِجَلْطة في دمِهِ، أو بِوَرمٍ في صدْره، يدعُ الدّخان فوْرًا، لكن متى ودعهُ؟-ودع ماضي يدع وإن كان غير مستعمل هذا الفعل-حينما يُدْرك خطر الدخان عن طريق المُعايَنَة، من هو العاقل؟ هو الذي لا يحتاج أن يكون هو التجربة، لا يتَّعِظ بنَفسِهِ، يتّعظ بِغَيره.
العلم حاجة عليا في الإنسان:
لي صديق، له خال دارس في جامعات غَرْبِيَّة، وله منْصب رفيع، وله مكانة كبيرة، لكنّه مُدْمِن على الدخان، أُصيب بِمَرض خبيث، زارهُ صديقي في المستشفى، فقال هكذا باسْتِكبار: هذه السيجارة لها معي حِسابٌ طويل، لقد سبَّبَتْ لي ورمًا في الرّئة، وبعد أن أُشْفى من هذا المرض سأُحاسِبُها حِسابًا عسيرًا، لكنّ هذا المرض لمْ يُمْهِلْهُ حتى يُحاسبَها حسابًا عسيرًا، قضى عليه.
قرأتُ بِكِتاب عن الدّخان أنّ إنسانًا مَشْهور جدًّا في الترْويج لبعض أنواع الدخان، له قِوام مُعَيَّن، يلبس لباس راعي البقر، إلى آخره، هذا الإنسان مات في رَيْعان الشباب بِسَرطان في الرئة بِسَبب الدّخان، وهو على فراش الموت قال هذه الكلمات، قال: كنتُ أكذبُ عليكم الدخان قتَلَنِي، إذًا حينما يترسَّخُ العلم تُخْلقُ الرّغبة في الطاعة، أو الرغبة في ترْك المعْصِيَة، أوائلُ هذه الرغبة تتولَّد من العلم، لذلك إن أردْت الدنيا فعليك بالعلم، وإن أردْت الآخرة فعليك بالعلم، وإن أردتهما معًا فعليك بالعلم.
الخُطْوَة الأولى والأساسيّة والمهمّة أنْ تعلَمَ، العِلْم حاجةٌ عُليا في الإنسان، حاجةٌ تليقُ بإنسانِيَّته، كلُّ مَن طلبَ العلم أكَّدَ أنَّه إنسان، ومن عزَفَ عن طلب العلم ألْغى إنْسانِيَّته، وحافظ على بَهيمِيَّتِهِ.
كلُّكم يعلم أنّ في الإسلام مقامات ثلاث: مقام الإسلام، ومقام الإيمان، ومقام الإحسان، وبالمناسبة أنا لا أرغبُ أبدًا أن أُضيف مصطلحًا لم يرِد لا في الكتاب ولا في السنّة، لا أستخدم أيّ مصطلح، نحن مع المضامين، ولسْنا مع العناوين، هذه المصطلحات مزَّقَت الأمّة، هذه المصطلحات شقَّت صفوف الأمّة، مصطلحات كثيرة، أنت مع الكتاب والسنّة، مع ما جاء في القرآن، ومع ما جاء من النبي العدنان، وهذا هو الإسلام، أما أن أُضيف مصطلحاً، أن أحذف مصطلحاً، هذا لم يرد.
طبعاً الإسلام أن تنْصاعَ لأمر الله، والإيمان أن تقْبِلَ عليه، والإحسان أن تعبد الله كأنَّك تراه، فإن لم تكن تراه فإنّه يراك، هذا مقام الإحسان، تحقيق مقام الإحسان أن يفْنى الإنسان بِحُبّ الواحد الدَيَّان، أن يفْنى بِحُبِّه، وأن يخاف منه، وأن يرْجُوَ رحمتهُ، وأن يتوكَّل عليه، وأن يتبتَّلَ إليه، وليس فوق ذلك المقام مقام، مقام الإحسان أن تعبد الله كأنَّك تراه.
والله أيها الإخوة؛ الإنسان إذا تعمَّق في الإيمان الحقائق تتَّضِح له شامخةً صارخة، يكاد المؤمن يعلم الغيب-هو لا يعلم الغيب أبداً-من ِمَعرفته بالقوانين، الإنسان منْحرِف، لابدّ من أن يؤدِّبَهُ الله تعالى، إنسان مُحْسن، لابدّ من أن يكرمَهُ الله تعالى، معرفتهُ بالقوانين تعطيهِ نَفَساً في الفراسة الصحيحة.
أيها الإخوة؛ الرّغبة من لوازمها الرِّعايَة، إن كنتَ راغبًا في شيءٍ عليك أن ترْعاهُ، إن اكْتَمَلَتْ الرغبة، اكْتَمَلَ معها خُلُق الرِّعاية الإيمانيّة، العِلْم كيف يُراعى؟ يُحْفظ ويُعْمَلُ به، آفاتا العلم أن يُنْسى وألا يُعْمَلَ به، الآن إذا كان هناك رغبة صادقة لابدّ من أن يتْبَعَ هذه الرغبة الصادقة عملاً يؤكِّد هذه الرغبة، فَرِعايَةُ العلم بالحفْظ، ورِعايَة العلم بالعمل.
على الإنسان أن يطلب العلم ثمّ يُعَلِّم:
هناك نقطة أتمنَّى أن تكون واضحة لديكم: إخواننا الكرام يحضرون دروس العلم كثيرًا، ويتأثَّرون، ويخرجون بانطِباع عن الدّرس، هذا الانطباع لا يلْبث أن يُنسى، فإذا كلّما حضرْت الدرس ترك الدرس انْطِباعاً ضبابياً، ثم لم تلْبَث أن ينسى الدرس، هنا مشكلة، هذا العلم كيف يتراكم؟ وكيف ينقلب إلى تعليم؟ وكيف ينقلب إلى طلاقة لِسان؟ وكيف ينقلب إلى دعوَة إلى الله عز وجل؟ الشيء الثابت أنّ الإنسان يطلب العلم ثمّ يُعَلِّم، يتلقَّى ثمّ يُلْقي، يأخذ ثمّ يعطي، هل يُعقل أن يعيش الإنسان طوال عمره في طلب العلم؟ هذا كلام غير مقبول، ما السبيل إلى أن أتذكّر الذي سمعتهُ؟ هذا يحتاج إلى مُذاكرة.
أنا أنصح كلّ إخواننا أربعة أو خمسة بِحَسب القرابة، بِحَسب المسكن، بِحَسب الجِوار، بحسب الزمالة بالعمل، على مستوى أسرة داخليّة، درس الجمعة، درس الأحد، درس الاثنين، إذا جلسْتَ مع أخيك ساعةً واحدة في الأسبوع مع بعض إخوانك الذين تجمعهم معك جامعة، جامعة الجِوار، أو جامعة العمل، أو جامعة القرابة، اتفقنا الأربعاء فرضاً الساعة السابعة بعد انتهاء العمل نجلس نتذاكر في درس الجمعة والسبت والأحد والاثنين والخطبة ماذا يحصل؟ هذه المذاكرة تخلق تراكماً، أنا أعرف بعض الإخوان الكرام انطباعه جيد جداً، وإيمانه قوي، يكون هناك جلسة يتمنى أن يتكلم لا يذكر شيئاً، ولا يذكر نصاً واحداً، عنده انطباع أن دروسنا رائعة لكن هذه لا تكفي، تحتاج مع الانطباع إلى تفاصيل، إلى معلومات، أنت بالنّهاية تطلب العِلْم كي تُعَلِّم، تتلقّى كي تُلقي، تأخذ كي تُعطي، العطاء يحتاج إلى تركيز، لذلك الذاكرة تُدَرَّب، حاوِلْ أن تكتب أجْمَلَ ما سمعْت، ثمَّ حاوِل أن تحفظَ أجْمَلَ ما كتبْتَ، لمجرد أن تحاول كتابة ما سمعت هذا الذي سمعته ترسخ في ذهنك، أحياناً بجلسة كل واحد منكم بالنسبة لمجتمعه نافذة من حوله إلى الله، أنت عند أهلك طالب علم، تلميذ بجامع النابلسي فرضاً، فأنت مظنَّة عِلْم، مظنَّة صلاح، لك أبٌ قد يكون بعيداً عن جوّ العلم، لك أخ، لك جار، لك صهر، لك ابن عمّ، تُسأل أنت دائمًا، تُدْعى إلى احتفال، إلى عقْد قِران، إلى تعزية، إلى نُزْهة، إلى سهرة، إلى وليمة، إلى لقاء، تبقى ساكتًا؟! اثنتا عشرة سنة تطلب علماً بالجامع تبقى ساكتاً؟! والله غير معقول، تطلب العلم كي تُعَلِّم، أجمل ما في الحياة أن تأخذ وتعطي، فإذا الإنسان حاوَلَ أن يكتب في البيت أجْمَلَ ما سمِع، ثم فليحاول ليحفظ أجمل ما كتب، بعد حينٍ صار عنده ذخيرة كبيرة جدًّا من المعلومات، أنا أتمنى على إخواننا دفتر صغير رقيق في الجيب، ممكن في هذا الدفتر سمع آية وطرب لِمَعناها سجلها.
سمِعَ مرَّةً قوله تعالى:
﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (55)﴾
إذاً الدِّين موصوف، ما قال: ﴿وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ﴾ قال: ﴿الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ﴾ معنى ذلك أنّ الدِّين الذي يرتضيه الله لنا هو سبب تمكيننا في الأرض، الآن استنباط منطقي صرف، فإن لمْ نُمَكَّن معنى ذلك أنّ الدِّين الذي نُمارسُهُ لم يرْتضه الله لنا، لذلك لمْ يُمَكِنَّ في الأرض، والله معنى لطيف جدًّا، هذا يحلّ مشكلة كبيرة، هذه الآية تُكْتب على دفْتر، يُشار إلى المعنى، دفتر صغير، سمعت معنى آية، حديث، حِكْمَة، بيت شعر رائع، حقيقة، حكم فقهي، هذه ذخيرة في جَيْبك، إن أردْت أن تحفظ فاكتُب، إن أردْت أن تُلقي فسَجّل، إن أردْت أن تعِظ فدَقِّق، فالعِلْم آفتهُ أن تنساه، لو قال أحدهم: حدَّثنا مثلاً سفيان بن عيينة، عن فلان، عن فلان، عن فلان، ساق ثلاثاً وثلاثين راوِيَة للحديث، أنّ النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان فيه خَصْلتان دخل الجنة، أما الأولى فقد نسِيَها الراوي، وأما الثانية فقد نسيتها أنا، لم يبْقَ شيء، هذه مشكلة، يتعلم، يأتي لِيَتَكَلَّم لا يذْكُر شيئًا، فقَيِّدُوا العِلْم بالكتابة.
قال: إذا اكتمَلَتْ رغبَتُهُ اكْتَمَلَ مع رغْبته خُلقُ الرِّعاية، يرعى العلم فيحْفظُهُ ويعمل به، ويرْعى العمل بالإحسان والإخلاص، الإحسان الإتقان، والإخلاص أن يكون خالصًا لله، دقيق هذا الكلام، يرعى العلم بالحفظ والعمل به، يرْعى العمل بالإحسان أي الإتقان والإخلاص، ويحفظ العمل من مُفْسِداته، مثلاً أعطى ثمّ منَّ بعْد عطائِهِ، فالمنّ أذْهَبَ ثواب عطائه.
قال العلماء: مراتب العلم والعمل ثلاث، رواية هي مجرّد النقل وحمْلُ المرْوِيّ، ودِرايَةٌ هي فهمهُ وتعَقُّلُ معناه، ورعايةٌ هي العمل بِمُوجِبِه، ما علمهُ وبِحَسب مُقتضاه، ما قولكم بهذا المثل؟ أنت أمام خارطة لِقَصْر، هذه أول مرتبة، الخارطة واضحة جدًّا، وقد رسمها أكبر مهندس، مساحات، الأبهاء، الطابق الأوّل، الطابق الثاني، الطابق الثالث، غرف النوم، غرف الجلوس، الشرفات، الحدائق، نسب الجدران، كلّ التفاصيل في هذه الخارطة، هذا نوع من العلم، فالذي أعطاك هذه الخارطة أعطاكَ علمًا، لكن أنت ليس عندك بيت، معك خارطة فقط، أما هناك عالم يدلّك على طريق القصر كي تسْلُكه، وهناك عالم ثالث يُدخلك إلى القصر لِتَسْكنهُ، فإنسان قدَّم لك خارطته، وإنسان دلَّك على الطريق الموصِلِ إليه، وإنسان أعانك على أن تدخلهُ، وأن تسكنه، وأن تستقرّ به، وفرقٌ كبير بين أن تمْتلك خارطة قصْر وبين أن تملك القصر، أو بين أن تمتلِكَ صورة سيارة وبين أن تملك السيارة.
مراتب العلم ثلاث، رِوايَةٌ؛ حدَّثنا فلان عن فلان، وهي مجرّد النقل وحمْلُ المرويّ، ودِرايةٌ هي فهمه وتعقُّل معناه، ورعايةٌ هي العمل بِمُوجبه، روايةٌ ودِراية ورعاية، ترْوي النصّ، وتفهم النصّ، وتعمل بالنصّ، لذلك قال الله عز وجل في مَعْرِض مديح المؤمنين، قال الله عز وجل:
﴿ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (121)﴾
علماء التفسير فسَّروا حقّ تِلاوته أن تنطق به صحيحًا، وأن تفْهمهُ، وأن تعمل به.
حقّ التقوى أن تُطيعهُ فلا تعصيه وتذكرهُ فلا تنساه:
قال: النَّقَلة همُّهم الرّواية، والعلماء همّهم الدراية، والعارفون بالله همّهم الرِّعايَة، واحد روى، والثاني درى، والثالث رعى، وقد ذمّ الله عز وجل من لم يرعَ ما اختاره وابتدعهُ من الرهبانيّة حقّ رعايته، ما معنى قوله تعالى؟
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (102)﴾
أيْ ارْعَوا التقوى، قال: حقّ التقوى أن تُطيعهُ فلا تعصيه، أن تذكرهُ فلا تنساه، أن تشكرهُ فلا تكفرهُ، قال تعالى:
﴿ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (27)﴾
هناك تعليق رائع، لأنّ الله ما كتبها عليهم لا يمكن أن يستطيعوا رعايتها، من هو الخبير؟ الله جلّ جلاله، إذا سمَحَ الله لك بالزواج، فإذا أنت حرمْت نفسكَ الزواج زهدًا وورعًا، أنت تحرَّكْتَ حركة بِخِلاف فِطْرتك التي فُطِرْت عليها، لن تستطيع رِعايَة هذا المسْلكَ الذي ابْتَدَعْتهُ، أجْمَل ما قيل في هذا المقام،
(( عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ ثَلاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلا أُفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا. فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: «أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي». ))
﴿وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا﴾ لأنَّهم ابْتَدَعوها ولم تَرِد في منهجهم إذًا لن يستطيعوا رعايتها حقّ الرعاية، ﴿مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ﴾ هم حينما كتَبُوها على أنفسهم اِدَّعَوا أنَّه ابْتِغاء رِضْوان الله، ولأنَّها لم تُكْتَب عليهم لمْ يستطيعوا رعايتها، ﴿فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا﴾ .
الآن دقق في هذا المعنى الدقيق؛ الله جلّ جلاله ذمّ من لمْ يرْعَ قُرْبةً ابْتَدَعها لله تعالى، لم يرْعها حقّ رعايتها، فكيف بِمَن لم يرْعَ قُرْبةً شرعها الله؟ القُربة التي لم يُشَرِّعها الله عاتب الذين ابْتَدَعوها أنَّهم لم يرْعَوْها حقّ رعايتها، ﴿فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا﴾ فكيف بالذي لا يرعى عبادة شرعها الله عز وجل، وهي متوافقةٌ مع طبْعِهِ ومع طاقته وقدرته وإمكاناته؟
الآن من أركان الرِّعاية رعايَة الأعمال وفْق النَّمَط الأوْسط مع اسْتصغارها والقيام بها من غير نظرٍ إليها، ثلاث صفات، رِعايَة الأعمال أن تأخذ الوضع المعتدل منها، فالإفراط تطرّف، والتفريط تطرّف، أن تُلقي بِنَفسِكَ إلى التهلكة تهوّر، وأن تَجْبُن عن ملاقاة العدوّ جبْنٌ، والوضْع الوسَطِيّ أن تكون شجاعًا بِتَعَقُّل، أن تُمْسِكَ المال بُخلاً، وأن تُلْقِيَهُ جزافًا إسرافًا، أما الوضْع الوسطي:
﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (67)﴾
أيها الإخوة؛ أوّل شيء رعاية الأعمال وفْق النَّمَط الأوْسَط، وقالوا: الفضيلة وسَطٌ بين طرفين، مع اسْتصغارها والقيام بها من غير نظرٍ إليها، الإنسان إذا رأى عملهُ كبيرًا حجَبَهُ عمله عن الله عز وجل، هذا شيء عال جداً، لو كان لك عملٌ كالجبال، يجب أن ترى أنّ الله تفضَّل به عليك، ولولا أنّ الله عز وجل تفضَّل به عليك لأخذْت ولم تُعْطِ.
مرَّةً أخ طلبَ مِني أن يشتغل، اتَّصَلْتُ بإنسان عندهُ معمل، أخٌ كريم وأنا أُحسِنُ الظنّ به، فاعْتذَر اعتذارًا لم أقْبلْهُ، هو ذكيّ جدّا، قلتُ له: والله الذي لا إله إلا هو مع أنَّك ذكيّ جدًّا، الله عز وجل قادِرٌ أن يجعلكَ تقف في صفّ طويل عند جمعِيَّة خيريَّة لتأخذ خمسمئة ليرة وتُوَقِّع، فأنت إذا أعطيت هذا من فضْل الله عليك، الذي يعطي يجب ألا يرى أنّه يعطي، يجب أن يرى أنّ الله تفضَّلَ عليه ومكَّنَهُ من أن يُعطي، الذي يتكلّم ويُلقي درساً يجب أن يشعر أنّ الله تفضَّل عليه أن جَعَلَ قُلوب المؤمنين تهْفو إليه، ولو انْصرفوا عنه من يستمع إليه؟
أنا أرى أنّ الذي يأخذ منك المال له فضْلٌ عليك، لو رفضَ حرمَكَ هذا العمل، والذي يأخذ منك العلم له فضلٌ عليك، لأنَّه لو انصرفَ عنك تُلقي الدرس على مَنْ؟ العِبْرة ألا ترى لك عملاً، ألا تزهوَ به، ألا يكون العمل حجابًا بينك وبين الله، ألا ترى هذا العمل، وأن تستصْغِرَه.
خذوا هذه القاعدة، اجعل لك هذه القاعدة؛ إذا إنسان أسْدَى إليك معروفًا يجب أن تسْتكبره، وألا تنْساهُ مدى الحياة، وإذا أنت قدَّمْت لإنسانٍ معروفًا يجب أن تستصْغِرَهُ، وأن تنْساه، وهناك أناسٌ بالعكس، إذا عُمِلَ معه أعمال كالجبال ينْساها، وإذا قدَّم لإنسان شيئاً بسيطاً، لا يزال يمنّ به عليه به حتى يخرج من جِلْدِهِ، يقول له: لحم كتفك من خيري، كلامٌ فيه حُمْقٌ، وفيه تَطاوُل، وفيه سوءُ أدبٍ مع الله، يقول لك: أنا مُعيل، لا، أنت مُعال ولسْتَ مُعيلاً، المُعيل هو الله.
يقول الإمام الشافعي: لو أنّ السماء من رصاص، والأرض من نُحاسّ، والخلقُ كلّهم عِيالي ما حملْتُ همًّا، لأنّ الله هو الرزاق ذو القوّة المتين.
علامة رضاء الله عنك إعراضك عن نفسك:
قيل: علامة رضاء الله عنك إعراضك عن نفسك، وعلامة قبول عملك احتِقاره واسْتِقلاله وصِغَره في قلبك، ما قولكم بِعَمل النبي عليه الصلاة والسلام؟
الإسلام الآن مليار ومئتا مليون إنسان، في مشارق الأرض ومغاربها، أينما ذهبْت؛ في أمريكا هناك ثلاثة آلاف مسجد، بفرنسا هناك ألف مسجد، بأمريكا هناك عشرة ملايين مسلم، بفرنسا الإسلام هو الدِّين الثاني، أينما ذهبْت تجدُ منارات إسلامِيَّة، مَن نشَرَ هذا الحق؟ في صحيفة من نحن جميعاً؟ سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم، إذاً ومع ذلك اسْتَمِع إلى قوله، قال: هذا جهْدُ مُقِلّ، فالتواضع أمر أساسي بالإيمان، من علامة رضاء الله عنك إعراضك عن نفسك، ومن علامة قبول عملك احتِقاره واسْتِقلاله وصِغَره في قلبك.
الحكمة من استغفار الله عقِبَ الصلاة:
الآن من يفسر لي لماذا تستغفر الله عقِبَ الصلاة؟! أوّل ما تنتهي الصلاة تقول: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، لماذا؟ أنت كنتَ بعبادة، كنت قائمًا تصلّي، والنبي كان يستغفر عقِب الحج، علمنا النبي صلى الله عليه وأنت في عبادة راقِيَة يجب أن تستغفر، وأن تشكر الله عز وجل أنْ قوَّاك على هذه العبادة، وإن كان هناك تقصير فيها، فعليك أن تستغفر.
التعامل مع النفس بالحبّ العقلي والبغض العقلي:
أيها الإخوة؛ الرغبة-يوجد شيء طريف سوف أقوله لكم، سمعتُه مرَّةً من طبيب فتأثَّرْتُ-قال: هناك حبّ نفسي، وحبّ عقلي، وهناك بغض نفسي، وبغض عقلي، إنسان أحياناً بالشتاء يجد فاكهة حامضة لا يحبّها، أما إن قالوا له: إنّ هذه الفاكهة الكبيرة تُذيب الكوليسترول، وتذيب الشُّحوم، ولها أثر كبير جدًّا، وفيها فيتامينات وفيها معادن، هو لا يحِبّها، لكن بِقَدر ما سمِعَ عن فوائدِها فصار يشربها ويأكلها، ما نسمي هذا الحب؟ هذا حُبّ عقلي.
وأحياناً تكون أمامك أكلة من أطْيَب الأكلات لكن لا تُناسبك، تُبغضها لا لأنك لا تحبّها بل لأنّها تؤذيك، فالإنسان كلّما ارتقى مُستواه لا يتعامل مع الحبّ النفسي، والبغض النفسي، يتعامل مع الحبّ العقلي، والبغض العقلي، يوجد أكلات طيبة جداً لكنها تؤذي من تجاوز الأربعين، وهناك أكلات لا يحبها صاحبها لكنها نافعة جداً، إذًا في النهاية ينبغي أن نتعامل مع أنفسنا بالحبّ العقلي والبغض العقلي، لا بالحبّ النفسي والبغض النفسي، الحبّ العقلي أن تطبّق منهج الله عز وجل،
(( عن عبد الله بن عمرو: لا يؤمِنُ أحدُكم حتى يكونَ هواه تَبَعًا لِمَا جِئْتُ به. ))
[ خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح، الذهبي ]
أي كلَّما ارْتَقَيْت تصبحُ مُيولك وفق منهج الله عز وجل، اللهمّ علِّمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علّمتنا وزدْنا علمًا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
الملف مدقق