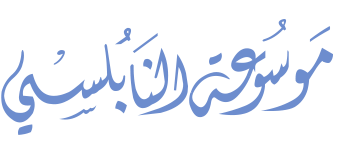الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.
الإنسان مخلوق لعبادة الله عز وجل:
أيها الإخوة الكرام؛ مع الدرس التاسع والتسعين من دروس مدارج السالكين، في منازل إيّاك نعبد وإيّاك نستعين، ولأن هذه الدروس التي تفضّل الله بها علينا على وشك الانتهاء فلابدّ من أن نتجه إلى تلخيص هذه المعاني المستفادة من أن الإنسان مخلوق لعبادة الله عز وجل، بل إن عبادة الله علة وجودك، ويمكن أن يمتلئ القلب طمأنينة حينما يستمع إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل سيدنا معاذ بن جبل،
(( قال: يَا مُعَاذ، هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ، وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ؟ قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَال: فَإِنَّ حَقُّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً -الآن السؤال المعاكس الذي يمــلأ القلب طمأنينة- قال: يَا مُعَاذ مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوا ذلِكَ؟ قَال: أَلاَ يُعَذِّبَهُمْ. ))
أي أنت حينما تعبد الله عز وجل أنشأ الله لك حقاً عليه ألا يعذبك، من منا يُحِب أن يُعذب؟ من منا يُحب أن يفتقر؟ من منا يُحب أن يمرض؟ من منا يُحب أن يخاف؟ حينما تعبد الله أنت تحت مظلة الله عز وجل، أنت في ظلّ الله يوم لا ظلّ إلا ظله، أنت في رعايته وعنايته وتوفيقه وحفظه، بل إن قول الله عز وجل مخاطباً النبي عليه الصلاة والسلام:
﴿ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ (48)﴾
تنسحب عليك بطريقة أو أخرى هذه الآية بقدر إيمانك وإخلاصك.
انحراف المسلمين كان حينما عبدوا الله وفق أمزجتهم واجتهاداتهم:
الإنسان كما تعلمون خُلِق هلوعاً، خُلِق شديد الخوف، وهذا ضعف في أصل خلقه، قال تعالى:
﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً(19) إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً(20) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً (21) إِلَّا الْمُصَلِّينَ(22)﴾
ما دمت متصلاً بالله فأنت بعيد عن الجزع، بعيد عن الهلع: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً*إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً*وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً*إِلَّا الْمُصَلِّينَ﴾ .
أيهاالإخوة؛ ولكن متى انحرف المسلمون؟ حينما عبدوا الله وفق أمزجتهم، ووفق اجتهاداتهم، ووفق بدع ما أنزل الله بها من سلطان، الله جلّ جلاله لا يُعبَد إلا وفق ما شرّع، فأية عبادة مبتدعة لم تَرِد لا في القرآن الكريم، ولا في سنة النبي عليه أتمّ الصلاة والتسليم فهذه عبادة لا يقبلها الله عز وجل.
العمل الصالح الذي يرضي الله في رأي الفُضيل بن عياض:
بل إن الفُضيل بن عياض رحمه الله تعالى سُئِل عن العمل الصالح الذي يرضاه الله عز وجل، في قوله تعالى:
﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (15)﴾
سُئِل عن العمل الصالح الذي يرضي الله عز وجل، قال: ما كان خالصاً وصواباً، وشرح هذا فقال: خالصاً ما ابتُغي به وجه الله، وصواباً ما وافق السنة، فهذا مقياس دقيق، النية الطيبة وموافقة السنة كلاهما شرط لازم غير كاف، لا يكفي أن تكون النية حسنة، ولا يكفي أن تطبق السنة من دون نية، فلابدّ من نية حسنة مع تقيد بالسنة حتى يُقبَل العمل، وحتى تكون العبادة منجاة للإنسان من عذاب الله.
أيها الإخوة؛ لعل النجاة في أن تُقايس، أو أن تقارن، أو أن توازن بين ما لك وما عليك، ما عليك من أخطاء، وما لك من ميزات، أو أن توازن بين ما قدمت وبين ما قدمه الله لك من نعمة الإيجاد، ونعمة الإمداد، ونعمة الهدى والرشاد.
صفات الشاردين عن الله عز وجل:
أيها الإخوة؛ الإنسان حينما يغفل عن سرّ وجوده، عن غاية وجوده، يتيه في الأرض، وكلمة ضياع، وتيه، وحيرة، وسوداوية، وانقباض، وكآبة، هذه كلها من صفات الشاردين عن الله عز وجل، أنت حينما تتعرف إلى الله، تتعرف إلى منهجه، تُوقِع حركتك اليومية وفق منهج الله فإنه من المستحيل أن تكون شقياً، قال تعالى:
﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا (4)﴾
أي ما من مخلوق يدعو الله عز وجل ويشقى بهذا الدعاء: ﴿وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيّاً﴾ .
الخصائص التي يحتاجها الإنسان لكي يحاسب نفسه:
قال: الإنسان حينما يحاسب نفسه يحتاج إلى خصائص ثلاثة، يحتاج إلى نور الحكمة، ويحتاج إلى سوء الظن بالنفس، ويحتاج إلى تمييز النعمة من الفتنة، فكم من فتنة توهمها الإنسان نعمة هي فتنة؟ معنى فتنة بالضبط أي شيء تُمتحن به، فإما أن تنجح، وإما أن ترسب، قال تعالى:
﴿ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (2)﴾
لابد من أن تُفتن، وإياكـم أن تفهموا من كلمة الفتنة المعنى السلبي، مجرد الامتحان، فقد تنجح، وقد تتفوق، وقد تعلو عند الله عز وجل، أما لابد من امتحان، لذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى سُئِل: أندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين؟ فقال: لن تُمكن قبل أن تبتلى، إن صحّ التعبير، هناك مرحلة التأديب، وهناك مرحلة الابتلاء، وهناك مرحلة التمكين، وهذه المراحل الثلاثة إما أن تتمايز، وإما أن تتداخل، فلابدّ من أن تُميز بين النعمة وبين الفتنة، قد يأتي المال وفيراً فيكون فتنة وليس نعمة، معنى فتنة أي حملك على المعصية، حملك على الكبر، حملك على الإسراف، حملك على التبذير، حملك على أن تحتقر الناس لأنهم فقراء، هذا المال ليس نعمة بل هو فتنة، إن صح التعبير كل حظّ من حظوظ الدنيا هو في الوقت نفسه نعمة وفتنة، نعمة إذا حملك على طاعة الله، وفتنة إذا حملك على معصية الله، إذاً حظوظ الدنيا سلم نرقى به أو دركات نهوي بها، لذلك أي حظّ آتاه الله إياك لا يُعدّ نعمة إلا إذا وُظّف في طاعة الله، وأي حظّ آتاه الله إياك يُعدّ نقمة إذا كان مسخراً لمعصية الله، والحظوظ تعلمونها؛ طلاقة اللسان حظّ، والوسامة حظّ، والغنى حظّ، والقوة حظّ، والصحة حظّ، ووقت الفراغ حظّ، هذه الحظوظ إذا وُظِّفت في الحق كانت نعمة وأية نعمة، أما إذا وُظِّفت في الباطل كانت نقمة وأية نقمة، فلابدّ من التمييز بين النعمة والفتنة.
التمييز بين النعمة وبين الفتنة:
أعجبني قول أحد العلماء، قال: هناك خيط رفيع جداً بين الخشوع وبين الطرب، أحياناً الإنسان يستمع إلى القرآن الكريم من قارئ شجي الصوت، حسن الأداء فيطرب، وهو يظن نفسه خاشعاً، أي هناك خشوع وهناك طرب، يُخشَى ألا نميز بين الطرب وبين الخشوع، الخشوع له صفات، أما الطرب له صفات، فحينما يعلو الصوت، وحينما تتجاوب مع نغم شجي في تلاوة القرآن، وحينما تضطرب فهذا طرب وليس خشوعاً، كذلك قد يتوهم الإنسان أن هذه نعمة، وهي في الحقيقة فتنة.
أي حظّ جرّك إلى معصية، جرّك إلى تساهل، جرّك إلى تقصير، جرّك إلى عزوف عن طلب العلم، جرّك إلى إيثار الدنيا على الآخرة، هذه فتنة وليست نعمة، وشتان بين النعمة والفتنة، فمن أجل أن تُحاسب نفسك حساباً عسيراً لابد من أن تمتلك القدرة على التمييز بين الفتنة وبين النعمة، سبحان الله! هناك أشخاص لا يرون لأنفسهم خطيئة، يُقَدّسون ذواتهم، ويرفضون أي نقص فيها، يرفضون أي انتقاد لتصرفاتهم، هؤلاء يعبدون ذواتهم من دون الله، لن تستطيع أن تُحاسب نفسك حساباً دقيقاً إلا إذا تمكنت من أن تسيء الظن بنفسك.
إحسان الظن بالآخرين وسوء الظن بالنفس:
أيها الإخوة؛ مناسبة جيدة كي أعطيكم هذه الحقيقة، عوّد نفسك أن تُحسِن الظن بالآخرين، وبشكل أخص بالمؤمنين، عوّد نفسك أن تلتمس لهم عذراً، عوّد نفسك أن ترى الوجه الإيجابي، عوّد نفسك أن تُحسِن الظن بهم، وعوّد نفسك أيضاً أن تُسيء الظن بنفسك، ألا تُحابيها، ألا تُجاملها، ألا تمتدحها، ألا تبرر عملها، ألا تُسوّغ خطأها، لذلك الصالحون شديدو المحاسبة لأنفسهم، سَيِّئُو الظنّ بها، سبحان الله! إذا أضلّ الله إنساناً أسبغ على نفسه مديحاً لا نهاية له، كأنه لا يخطئ، كأن كل أفعاله جيدة، أما المؤمن الصادق عمله الطيب يتهمه، لعل نيته لا ترضي الله، لعلي بهذا العمل فرحت بمدح الناس لي، فالمؤمن الصادق أعماله الخالصة يشك فيها، بينما المنافق أعماله السيئة يمتدحها، هذا معنى قول أحد التابعين: التقيت بأربعين صحابياً ما منهم واحد إلا وهو يظن نفسه منافقاً.
لذلك المؤمن يتقلب في اليوم الواحد في أربعين حالاً، بينما المنافق يستقر على حال واحد أربعين سنة، يُحسِن الظن بنفسه، ويُسبغ على نفسه كل صفات العظمة، وينتقد الناس جميعاً، وهو ليس كذلك، إذاً لابد من تمييز النعمة عن الفتنة، ولابد من سوء الظن بالنفس:
فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النهم
محاسبة عمر لنفسه:
يروى أن سيدنا عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، كان يخطب بالمؤمنين في أيام خلافته، فجأة قطع الخطبة، وقال كلاماً لا معنى له، قال كلاماً لا ينسجم مع موضوع الخطبة، قال: يا بن الخطاب! كنت راعياً ترعى الإبل على دريهمات لأهل مكة، وتابع الخطبة، فلما انتهت الخطبة، صار هناك سؤال، سأله بعض أصحابه: لماذا قلت هذا الكلام؟ وما علاقته بالخطبة؟ فقال سيدنا عمر: جاءتني نفسي وقالت لي: ليس بينك وبين الله أحد، أي أنت قمة المجتمع، هو فعلاً خليفة المسلمين، كل الناس دونه، خليفتهم هو أمير المؤمنين، ثاني الخلفاء الراشدين، قال عنه النبي: لو كَانَ نبيٌّ بعدي لكَانَ عُمَر بنُ الخَطَّابِ، سماه المؤرخـون عملاق الإسلام، أتت آيات كثيرة موافقة لاجتهاده، حتى سُمِّيت هذه القضايا بالموافقات، كان النبي يحبه حبّاً جماً، فلما قالت له نفسه: ليس بينك وبين الله أحد، أعجبته نفسه، فأراد أن يُعَرّفها قدرها وهو على المنبر، قال: يا بن الخطاب كنت ترعى الإبل على قراريط لأهل مكة، من أنت؟ وفي بعض الروايات يقول لنفسه: كنت عميراً فأصبحت عمراً فأصبحت أمير المؤمنين.
إخواننا الكرام؛ وهذا ما أتمناه عليكم وعلى نفسي، لا تتساهل مع نفسك، حاسبها حساباً عسيراً، لا تحابها، أسيء الظن بها، وعلى العكس افعل مع إخوانك، أحسن الظن بهم، التمس لهم المعاذير، أما هناك أناس والعياذ بالله! إذا أصابتهم مصيبة، قال: هذه ترقية، أما إذا أصابت غيرهم مصيبة، قال: هذا عقاب، يتهم إخوانه بالتقصير، ويمتدح نفسه، ويصف كل مصائبها على أنها ابتلاء، فهناك من أجل أن تحاسب نفسك تحتاج أن تُوازن بين الفتنة والنعمة، وأن تُسيء الظن بنفسك، ولا أن تحابها، بل أن تُحسن الظن بغيرك، وشيء آخر هو أن تمتلك نور الحكمة.
إخواننا الكرام؛ لا أبالغ إذا قلت كما قال الله تعالى:
﴿ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاء وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (269)﴾
أي شيء لا يعدل أن تُؤتى الحكمة، من أوتي الحكمة عاش سعيداً ومات حميداً، من أوتي الحكمة كان أسعد الناس في الدنيا، وأنجاه من عذاب النار في الآخرة، بل إن الحكمة هي نور الله، فحينما تفتقد الحكمة فمعنى ذلك أن القلب مغلف بشيء لا يرضي الله عز وجل، أما إذا كان القلب مفتوحاً فالحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها أخذها.
أيها الإخوة؛ الذي يُحاسب نفسه حساباً عسيراً، لابدّ من أن يعرف الأمر التكليفي والأمر التكويني، الأمر التكليفي أي افعل ولا تفعل، كيف تُقيِّم نفسك ولا تعرف المقياس الذي ينبغي أن تقيس به نفسك؟ قال لك: أنا جيد، هل درست أحكام الشريعة؟ هل عرضت أعمالك على ميزان دقيق؟ الشريعة ميزان، وقد قال بعض علماء التفسير في قوله تعالى:
﴿ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (7)﴾
الله أعطانا ميزاناً، هو عندك ميزان العقل، وهناك ميزان الفطرة، أما العقل قد يضلّ، والفطرة قد تنطمس، أما الميزان الذي لا يَضِلّ ولا ينطمس هو الشرع، لذلك قالوا: الحسن ما حسَّنه الشرع، والقبيح ما قبَّحه الشرع.
الشرع ميزان الموازين، ميزان مركزي، ميزان تُوزن به الموازين، تماماً كما لو أعطيت طالباً مسألة في الرياضيات، وكتبت له رقماً في نهاية المسألة، قلت له: هذا الرقم هو جواب حلّ المسألة، فإن حللت المسألة في ساعات طويلة، وانتهيت إلى هذا الجواب، فعملك صحيح، وإن انتهيت إلى رقم آخر، فحلك غير صحيح، انتهى الأمر، فأنت فكر، وحلل، وادرس، إن وجدت تفكيرك ينتهي بك إلى طاعة الله فالتفكير سليم، والعقل صريح، أما إذا انتهى تفكيرك وعقلك إلى شيء آخر لا يُرضي الله فالتفكير غير سليم.
إذا قال لك أحدهم: معي مبلغ من المال، لا أستطيع أن أدعه مجمداً هكذا، أخاف أن يفقد قيمته مع التضخم النقدي، فلابد من استثماره في جهة آمنة، وليس هناك من جهة أشدّ أمناً من البنوك، هكذا فكر، معي قرشان، لو جمدت هذا الرقم لأكله التضخم، إذاً لابد من استثماره في جهة آمنة وأفضل جهة أمنة البنوك، إذاً أنا منصرف إلى وضع المال في البنك، نقول له: إذا انتهى بك التفكير، وانتهت بك المحاكمة إلى أن تستثمر مالك في مؤسسة ربوية، وقد قال الله عز وجل:
﴿ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279)﴾
نقول له: تفكيرك غير صحيح، إنسان آخر قال لك: المرأة نصف المجتمع، إن وُجدت في مجتمع الرجال يتجملون، يضبطون كلامهم، يُحسّنون ألفاظهم، فكأنها عنصر ضابط، عنصر مهدِّئ، ظهر معه بالنهاية لابد من الاختلاط، نقول له: تفكيرك غير سليم، لأن هذا التفكير انتهى بك إلى شيء حرمه الله عز وجل، تماماً كأن تُعطى مسألة رياضيات، ومعها رقم، فإذا انتهى بك الحل إلى هذا الرقم فالحل صحيح، إذا انتهى بك الحل إلى رقم آخر فالحل غير صحيح، هذا معنى قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ﴾ أعطاك ميـزان العقل، وأعطـاك ميزان الفطرة، ولعـل الفطرة تنطمس، ولعل العقل يضل، أعطاك ميزاناً لا يُخطئ إنه الشرع، فالحسن ما حسَّنه الشرع، والقبيح ما قبَّحه الشرع، فأنت في مجال محاسبة نفسك، يقول لك أحدهم: ماذا نفعل؟ هو يفعل كل الموبقات ماذا نعمل؟ لأنه لا يوجد عنده ميزان.
ضرورة معرفة دقائق الشرع حتى تكون هذه الدقائق ميزاناً لك في محاسبة النفس:
لا يوجد عنده ميزان لما ينبغي أن يقال، أو لا يقال، لا يوجد عنده ميزان لما ينبغي أن ينظر أو لا ينظر، لا يوجد عنده ميزان لما ينبغي أن يعطي أو لا يعطي، يتحرك حركة عشوائية، يتحرك بنزوات، يتحرك بشهوات، يتحرك بمصالح، ولا يوجد شرع يضبطه، ولا معلومات تُقيده، كيف تحاسب نفسك إن لم تملك الميزان؟ الميزان هو الشرع، إذاً ما دمنا في محاسبة النفس، ومحاسبة النفس تمهيد لطاعة الله عز وجل، لابد من أن تعرف منهج الله على التفصيل كي تجعل من هذا المنهج ميزاناً لأعمالك.
أحياناً هناك بالفقه فروع دقيقة جداً، مرة درّست هذه الفروع وأذكر من جملتها آداب الطعام، فإنسان مثلاً دُعِي إلى طعام، وهناك أناس كثيرون يأكلون معه، هو انتهى رأساً يبتعد عن المائدة، ويجلس في مكان بعيد، أو يطلب أن يُغَسّل يديه، وهو يرى أنه يقوم بألطف عمل، أنت أكلت طعاماً سريعاً أو لم تكن جائعاً كما ينبغي فلما ابتعدت عن المائدة أحرجت الآخرين، فالسُّنة تقتضي أن تبقى معهم، أن تبقى في مكانك، دون أن تزيح عن مكانك حتى ينتهي الحاضرون، وجودك على المائدة عمل لطيف، أما لمجرد أن تنتهي من الطعام انسحبت، انسحب اثنان، ثلاثة، بقي واحد لوحده، فترك الأكل وقام وهو جائع، فهناك دقائق في الشرع دقيقة جداً، كيف تُحاسب نفسك إن لم تعرف هذه الدقائق؟ لذلك لابدّ من معرفة دقائق الشرع حتى تكون هذه الدقائق ميزاناً لك في محاسبة النفس.
شيء آخر؛ حينما تعلم أن الأمر التكويني بيد الله عز وجل، الآلام التي تُحطِّم النفس قد لا تأتيك، ذلك أن الإنسان إذا وحّد الله عز وجل ارتاحت نفسه، هذا الذي وقع أراده الله، وهذا الذي أراده الله وقع، وهذه الإرادة متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق،
(( عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيقَةٌ، وَمَا بَلَغَ عَبْدٌ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ، وَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ. ))
[ أحمد: الهيثمي: مجمع الزوائد: رجاله ثقات ]
انتهى الأمر، التوحيد هو الدين، التوحيد هو العلم، التوحيد هو نهاية العلم، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، التوحيد ألا ترى مع الله أحداً، ألا ترى فاعلاً إلا الله، ألا ترى رازقاً إلا الله، ألا ترى مُعِزّاً إلا الله، ألا ترى مُذلّاً إلا الله، ألا ترى معطياً إلا الله، ألا ترى مانعاً إلا الله، ألا ترى رافعاً إلا الله، ألا ترى خافضاً إلا الله، علاقتك مع واحد، فإن أرضيته:
فليتك تحـلو والحياة مريــرة وليتك ترضى والأنام غضاب
وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبـين العالمين خــراب
الحال مُسعد لكن العلم حاكم عليه:
ما دمنا في محاسبة النفس أيها الإخوة؛ في موضوع الحال يهمني أن تعرفوا عنه شيئاً، المؤمن تعتريه أحوال، بعض هذه الأحوال مُسعد، وبعض هذه الأحوال مُزعج، أحياناً يشعر بالانشراح والتألق والسرور والتفاؤل، ويظهر هذا في حركاته، وفي لمعان عينيه، وفي زئبقية عينيه، وفي تورّد خده، وأحياناً ينقبض، هذا الحال أيها الإخوة؛ هناك من يتعلق به، ويراه كل شيء، هناك من يراه حكَماً حاسماً، الحال مُسعد لكن العلم حاكم عليه، إليكم الدليل؛ مثلاً رجل فقير جداً جداً، أعطيته ورقة مالية بمئة ألف أو بمليون، وقلت له: هذه لك، هذه الورقة قد تكون مزورة، هو لا يعلم أنها مزورة، يشعر بسعادة وطمأنينة وثقة وامتلاء، صار معه مبلغ ضخم، أليس هذا الحال وهماً؟ إذاً ما كل حال صحيح، هل يعقل أن يكون هذا الحال عند الله مقبولاً؟ إذاً ما كل حال يقبله الله عز وجل، هناك حال رحماني، وهناك حال شيطاني، من الذي يحكم على هذا الحال أهو صواب أو خطأ؟ هو القرآن والسنة، إذا أنت أديت طاعة وتألقت بعدها، فهذا الحال رحماني، إذا أنفقت مالك في سبيل الله، وشعرت بتألق بعد إنفاق المال، فهذا الحال رحماني، أما إذا استطعت أن تقترف إثماً، وأن تُمتع نفسك إلى حين، وفرحت بهذا الإثم، فهذا حال شيطاني، فالفرح مطلقاً، والتألق مطلقاً، والشعور بالامتلاء والزخم الروحي مطلقاً، هذا يحتاج إلى علم ليكون حَكَماً على الحال، مع أن الحال سُمِّي حالاً لأنه يحول، لا يستقر.
لكن خير شاهد على هذا على الحال الرحماني، أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه الصّدّيق مع سيدنا حنظلة، وكان حنظلة في الطريق يبكي، مرَّ به الصديق، قال له:
(( عَنْ حَنْظَلَةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، فَوَعَظَنَا، فَذَكَّرَ النَّارَ، قالَ: ثُمَّ جِئْتُ إلى البَيْتِ فَضَاحَكْتُ الصِّبْيَانَ وَلَاعَبْتُ المَرْأَةَ، قالَ: فَخَرَجْتُ فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ فَذَكَرْتُ ذلكَ له، فَقالَ: وَأَنَا قدْ فَعَلْتُ مِثْلَ ما تَذْكُرُ، فَلَقِينَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، فَقُلتُ: يا رَسُولَ اللهِ، نَافَقَ حَنْظَلَةُ فَقالَ: مَهْ فَحَدَّثْتُهُ بالحَديثِ، فَقالَ أَبُو بَكْرٍ: وَأَنَا قدْ فَعَلْتُ مِثْلَ ما فَعَلَ، فَقالَ: يا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً، ولو كَانَتْ تَكُونُ قُلُوبُكُمْ كما تَكُونُ عِنْدَ الذِّكْرِ، لَصَافَحَتْكُمُ المَلَائِكَةُ، حتَّى تُسَلِّمَ علَيْكُم في الطُّرُقِ. وفي رواية: كُنَّا عِنْدَ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ فَذَكَّرَنَا الجَنَّةَ وَالنَّارَ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَديثِهِمَا. ))
هذا الشيء واقع جداً، كل واحد تقريباً بالجامع مع إخوانه، يوجد عبادة، يوجد جلسة روحانية، يقول لك: والله أنا مسرور جداً، أما إذا ذهب إلى البيت، قد يكون الطعام متأخراً، قد يتأخر ابنه عن البيت، يسأله، يعلو صوته عليه، هذا الحال الرحماني يضيع منه، قال: نكون مع رسول الله ونحن والجنة كهاتين فإذا عافسنا الأهل ننسى، سيدنا الصديق من شدة كماله وتواضعه قال لحنظلة: أنا كذلك يا أخي، انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاءا النبي عليه الصلاة والسلام، قال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء، تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا، أما أنتم يا أخي فساعة وساعة، لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة، ولزارتكم في بيوتكم، هذا ما يُعَبّر عنه بالشفافية، كان عليه الصلاة والسلام يقول:
(( عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي لأَعْرِفُ حَجَرًا بِمَكَّةَ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ، قَبْلَ أَنْ أُبْعَثَ إِنِّي لأَعْرِفُهُ الآنَ. ))
(( وعن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب قال: أردفني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خلفه ذاتَ يومٍ فأسرَّ إليَّ حديثًا لا أُحدِّثُ به أحدًا من النَّاسِ وكان أحبُّ ما استتر به النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لحاجتِه هدفًا أو حائشَ نخلٍ، فدخل حائطًا لرجلٍ من الأنصارِ فإذا فيه جملٌ فلمَّا رأَى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حنَّ وذرِفت عيناه فأتاه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فمسَح ذِفراه فسكت فقال من ربُّ هذا الجملِ لمن هذا الجملُ فجاء فتًى من الأنصارِ فقال لي يا رسولَ اللهِ فقال أفلا تتَّقي اللهَ في هذه البهيمةِ الَّتي ملَّكك اللهُ إيَّاها ؛ فإنَّه شكَى إليَّ أنَّك تُجيعُه وتُدئِبُه. ))
هناك تواصل، بل إنّ النبي عليه الصلاة والسلام حبنما كان يخطب على شجرة، ثم نُصب له منبر، حنت إليه الشجرة، فكان يضع يده عليها في أثناء الخطبة تكريماً لها، هذا مقام الأنبياء، لكن المؤمن على شيء من هذه الأحوال، هناك انسجام مع الطبيعة والكون.
الله عز وجل لا يُعبد إلا وفق شرعه:
أيها الإخوة؛ كل حال صحبه تأثير في نصرة دين الله عز وجل، والدعوة إليه، فهو مِنّة وإلا فهو حُجّة، وكل قوة ظاهرة وباطنة صَحِبها تنفيذ لمرضاته وأوامره فهي منة وإلا فهي حُجة، وكل مال اقترن به اشتغال بما يُرضي الله عز وجل فهو مِنة وإلا فهو حجة، وكل قبول في الناس وتعظيم ومحبة اتصل به خضوع لله عز وجل وذلّ وانكسار ومعرفة بعيب النفس والعمل فهو مِنة وإلا فهو حُجّة، أي العلم حكم على الحال.
من خلال هذا الدرس أريد أن أؤكد لكم أن الله عز وجل لا يُعبد إلا وفق شرعه، وأية إضافة على الدين بدعة، وأي حذف من الدين بدعة:
﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3)﴾
لابدّ من أجل أن تعبد الله من أن تعرف الأمر التكليفي والأمر التكويني، ولابدّ من أن تُفرِّق بين الفتنة والنعمة، ولابدّ من أن تُسِيء الظن بنفسك، ولابدّ من حكمة تكشف بها الحق من الباطل، ثم إن الحال والعمل، الحال والعلم متكاملان، فالعلم حكم على الحال، وليس الحال حكماً على العلم، وهذا محور الدرس إن شاء الله تعالى، وأرجو الله أن ينفعنا بما علمنا، وأن يُلهمنا تطبيق ما تعلمناه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
الملف مدقق